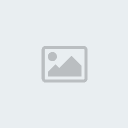الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فعن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ قَلْبَكَ غِنًى، وَأَمْلأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، ابْنَ آدَمَ لا تَبَاعَدْ عَنِّي فَأَمْلأْ قَلْبَكَ فَقْرًا، وَأَمْلأْ يَدَيْكَ شُغْلا) رواه الحاكم والطبراني، وصححه الألباني.
إن قضية الرزق والكسب، والغنى والفقر من أكبر ما يشغل بال الإنسان في كل مكان وعبر التاريخ والزمان، بل إن البعض جعل قضيته الأولى في الحياة هي "لقمة العيش" من طعام وشراب وسائر حاجات الجسد ظاناً أن بلوغ الرفاهية في ذلك هو سبب السعادة في هذه الحياة، بل ربما سفكت الدماء وقامت الحروب من أجل هذه القضية.
وإنما سعادة الإنسان وراحته تكون بحال قلبه، وتصوره وسلوكه في الحياة؛ فإن الفقر وإن كان ابتلاءً يبتلي الله به عباده إلا أنه يرتبط بعقيدة الإنسان ونظرته لهذه الحياة وهدفه الذي من أجله يعمل في هذه الدنيا، لذا فقد قال -عز وجل- في الحديث القدسي: (يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأُ قَلْبَكَ غِنًى وَأَمْلأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، ابْنَ آدَمَ لا تُبَاعِدْ مِنِّي فَأَمْلأُ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلأُ يَدَيْكَ شُغْلا).
والتفرغ لعبادة الله يكون بتفريغ الهم والإرادة لله وحده، وليس المقصود أن يمكث الإنسان في المسجد دون سعي لكسب أسباب معاشه، فإن الله أمر عباده أن يمشوا في مناكب الأرض سعياً للرزق؛ قال -تعالى-: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)(الملك:15)، وأمرهم بالسعي لأكل الحلال وترك الحرام، ونهاهم عن سؤال الناس، بل أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةُ -قطعة- لَحْمٍ) متفق عليه.
فسؤال الناس شيئاً من دنياهم يحدث الخلل في المجتمع وفي شخصية الإنسان نفسه.
وتفريغ الهمّ لله وحده هو قضية اعتقادية بأن يكون همّ المرء في هذه الحياة عبودية الله -عز وجل- بمفهومها الذي يشمل كل جزئيات الحياة؛ قال -سبحانه-: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)(الأنعام:162-163)، فتكون حياته وقفاً على هذا الهدف، يريد أن يحققه في كل نواحي حياته بتصديق خبر الله والتزام شرعه، وتنفيذ أمره واجتناب نهيه، واتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم- في كل دقائق حياته؛ عندها يحصل له الخير، وتتسع أمامه أبواب الخير كلها، ويرى بقلبه ما لم تكن تراه عينه.
(أَمْلأُ قَلْبَكَ غِنًى):
إن الغنى... غنى القلب والنفس (لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ) متفق عليه، فليس كثرة ما في جيب الإنسان وخزائنه هو حقيقة الشعور بالكفاية، بل مهما امتلأت الخزائن فلن يزل المرء يشعر بالفقر إن لم يستغن بعبادة الله، ليس الغنى بكثرة ما مع الإنسان، بل باستغناء القلب بعبودية الله، وحاجة الإنسان للمال، والجنس، والطعام والشراب والوجاهة عند الناس كل هذه لا تسد إلا جانباً صغيراً من حاجاته، أما الجانب الأكبر والأعظم فلا يزال الإنسان يبحث عنه، وهو حاجته إلى أن يتوجه بإرادته وحبه، وخوفه ورجائه إلى إله واحد لا شريك له، ولا يستقر القلب ولا تطمئن نفسه إلا إذا توجه إليه خوفاً ورجاءً، وتوكلاً وإنابةً، وحمداً وشكراً، وصبراً ورضاً عندها يستغني القلب بالله -تعالى-.
إن مشكلة الغلاء وصعوبة أسباب المعاش، وقلة العمل وقلة البركة في الكسب كل هذه تـُحل تلقائياً إذا كان الإنسان مستغنياً بالله -تعالى- فيسهل عليه التنازل عن كثير من الترف والرفاهية، وربما حاجاته الأساسية؛ لأنه استغنى بمولاه -تعالى-.
فقد عاش النبي -صلى الله عليه وسلم- يعاني حياته من الجوع، ومع ذلك كان مطمئناً لا يعبأ بما هو فيه، كان يأتي على أهله الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار، فهل من فقراء المسلمين ممن نبكي لشدة حالهم وسوء معاشهم، هل منهم من وصل حاله لهذا؟! أو حتى يقوى على أن يتحمل مثل هذا، فكيف تحمله النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحبه إذن؟!
خرج -صلى الله عليه وسلم- يوماً وقت الظهيرة في شدة الحر، وما أخرجه إلا شدة الجوع؛ فيلقى الصديق -رضي الله عنه، والذي كان من أغنى تجار المسلمين والذي تصدق بماله كله أكثر من مرة- بل ويلقى الفاروق -رضي الله عنه- وما أخرجهما إلا الجوع، فيقول -صلى الله عليه وسلم-: (وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا) ثم ينزلون أضيافاً على أبي الهيثم بن التيهان -رضي الله عنه- فيذبح لهم شاة، ويطعمهم من التمر والبسر ثم يشربون الطيب من الماء، ثم يقول لهم -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه مسلم.
يدخل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين اعتزل نساءه شهراً كاملاً لما سألنه مزيداً من النفقة مما ليس عنده -صلى الله عليه وسلم- فوجده قد نام على الحصير، وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، وما في غرفته إلا قربة ماء وإهاب يعد للدباغ، وما في غرفته ولا خزائنه شيء آخر -صلى الله عليه وسلم- فبكى عمر -رضي الله عنه- لما رأى هذه حاله -صلى الله عليه وسلم-، وكسرى وقيصر في ذات الوقت يتنعمون في قصورهم، وهو أحب الخلق إلى الله وأقربهم إليه وأفضلهم -صلى الله عليه وسلم-، فيقول له -صلى الله عليه وسلم-: (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ) متفق عليه.
فلو كانت السعة كرامة عند الله لأعطاها لأنبيائه -عليهم الصلاة والسلام-، بل كمال الأنبياء ألا يكونوا ملوكاً؛ لذا اختار -صلى الله عليه وسلم- أن يكون عبدا رسولاً لا ملكاً نبياً لما خـُيـِّر بينهما فأشار إليه جبريل -عليه السلام- أن تواضع لربك.
وكان خلفاؤه -صلى الله عليه وسلم- على هذا النهج من بعده، فكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أميرا للمؤمنين وجيوشه في المشارق والمغارب وهو يخطب على المنبر وثوبه مرقع ويخبر الناس أنه استقرض من عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- شيئاً من ثيابه، وجاع -رضي الله عنه- مع المسلمين عام المجاعة إلى أن يسر الله لهم من الخير من الأقطار المفتوحة.
ولما أتاه الصحابة بالهرمزان أحد ملوك الفرس، وقد بهرهم حلله وثيابه فأتوه به ليريوه كيف أعزهم الله على هذا الملك والغنى. فسأل عن عمر فقيل له: إنه نائم في المسجد!!
قال: أليس له بوابون؟!
قالوا: لا!!
قال: أليس لديه حرس؟!
قالوا: لا!!
قال: أهو نبي؟؟!
قالوا: لا، ولكنه يعمل بعمل الأنبياء!
فلما استيقظ عمر من الجلبة التي أحدثها ونظر إليه, استعاذ بالله من منظره الذي يذكره الدنيا، وما رضي أن يكلمه حتى ينزع عنه زينة الدنيا.
فالملك في أمتنا نقص (الْخِلاَفَةُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكاً بَعْدَ ذَلِكَ) رواه الترمذي، وصححه الألباني، وأما العبودية فهي العز كل العز؛ لذا لما حققها صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- هان عليهم أن يتحملوا هذه الابتلاءات، فقد خرج بضعة عشر صحابي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يعودون سعد بن عبادة -رضي الله عنه- في مرضه يسيرون في طرقات المدينة وجوَّها الحار ليس على أحدهم خفاف، ولا نعال، ولا قلانس ولا عمائم، ولا قمص، لا يرتدون إلا الأزر، ومع ذلك كانوا سعداء؛ فالغنى لا يكون سبباً لسعادة الإنسان إلا لو كان غنى القلب.
لذا فقضية الغلاء والفقر والكسب والغنى تهون جداً، وتهون كثير من المشاكل لو كان القلب غنياً بحب الله... بآياته... بالركوع والسجود له... بخوفه ورجائه وحده... بتعظيم حرمات الله الذي يمنعه من أكل الحرام أو سفك الدماء في سبيل لقمة العيش، أو البغي على حق الغير لأجل الرزق والكسب، فالأمر عنده هين؛ إذا جاع يوماً فقد شبع يوماً آخر، ويقول الحمد لله الذي جعل لي ما أتجمل به، أكسو به عورتي، وأسد به جوعي أحياناً، فإن هذا يكفيه مع غنى النفس، ولعل من حِكَم الصيام أن يذوق الإنسان الجوع، فإذا تعرض إليه يوماً كان هيناً عليه.
خرج ثلاثمائة صحابي في سرية مع أبو عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه- وما كان زادهم إلا جراب تمر، قوت أحدهم في اليوم تمرة واحدة طيلة ما يقرب من شهرين كاملين! كيف تحملوا ذلك فقد كانوا مع هذا الضيق مجاهدين في سبيل الله؟!
إنها العزة والكرامة رغم الحاجة والفاقة؛ فالفقر في الحقيقة فقر القلب، فلو افتقر الإنسان إلى الدنيا ذل، ولو استغنى عنها وعن الناس عز، ولن يستغني القلب إلا بالله -عز وجل-.
(وَأَمْلأْ يَدَيْكَ رِزْقًا):
يأتي الرزق بعد غنى القلب فحينها يكون نفعاً للإنسان، ولو أتى قبل أن يمتلأ القلب بالغنى كان والله أعظم الضرر، وكان سبباً لأن يظل عبداً لهذا الرزق؛ للدرهم والدينار (تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِىَ رَضِىَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ) رواه البخاري.
فيمتلأ القلب بهذا السم الناقع... سم حب الدنيا والتعلق بها وعبوديتها؛ فلابد أن يمتلأ القلب أولا بالغنى... بالتفرغ لعبادة الله، وتفريغ الهم والإرادة والتعلق له -سبحانه- وحده، وأن تكون العبودية هي المهمة الأولى، لا أن تكون قضيته الأولى أن يطعم الأولاد أو يأتي بالمال أو يأكل عيشاً من أجله يبيع دينه ويشتري ذل الدنيا، ويقول: ماذا أصنع؟!
يأكل الربا ويأخذ الرشا ويعمل بالحرام، ويبيع عرضه وأمانته، وعبادته ويقول: أريد أن أطعم أولادي... أريد أن أعيش؟!
ووالله ما انتشر العمل الحرام وما قل العمل الحلال إلا لأن القلوب لم تستغن بالله فضاقت عليها الدنيا، والرزق إن جاء والقلب لم يستغن بعد ظل القلب فقيراً تعيساً باحثا عن لذاته المزيفة التي يدمر بها نفسه في الحقيقة؛ فإن وجد في يديه مالاً ذهب ووقع به في الشهوات المحرمة، وهذا من أعظم أسباب التعاسة الفظيعة، وحال كفار الغرب ومن اتبعهم على دربهم واضح بيّن، يعمل أحدهم العمل الدءوب طيلة خمسة أيام في الأسبوع ثم في عطلته يعاقر الخمر والمخدرات والمومسات؛ ليهرب من ألم فقر قلبه، ويعيش في سكرة ووهمّ لا ينتهيان به إلا إلى السعير.
ومع أشد الأسف إن هذه الشهوات المحرمة تملأ السهل والوادي لا يسلم منها إلا من رحم الله -عز وجل-، مع أنها تؤلم القلب وتدمره فمجرد رؤية وجوه -فقط وجوه- المومسات هذا من العذاب فما لنا بما طمّ وعمّ في الفضائيات والمواقع الإباحية وعلى الهواتف المحمولة، كيف يتلذذون بها؟!
بل كيف بمن نكست فطرته تماماً واستمتع بالممارسات الشاذة؟!
كل ذلك لأن القلوب لم تعرف ربها ولم تستغن به، فتلهث وراء سراب فإذا ما جاءته لم تجده إلا مزيداً من الألم والعذاب.
(لا تَبَاعَدْ عَنِّي فَأَمْلأْ قَلْبَكَ فَقْرًا، وَأَمْلأْ يَدَيْكَ شُغْلا):
وهكذا كلما بعدت القلوب عن ربها والميل إليه كلما زاد شعورها بالضيق والفقر والحاجة ولو جمعت لها متع الدنيا بحذافيرها فإنها لا تغنيها، بل تزيدها ضنكاً وفقراً، وفي نفس الوقت تمتلئ الأيدي شغلاً بالليل والنهار ولهثاً وراء الدنيا، ولكن لا كفاية ولا سد للحاجات فلا غنى للقلب ولا غنى للبدن، بل وتزداد الأحوال سوءاً كلما ازدادت القلوب بعداً.
وبالتالي تزداد الأزمة -الاقتصادية والغلاء وقلة البركة- سوءاً، وتزداد البلايا والمحن حتى تعم الفتن فتصبح -والعياذ بالله- (فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) تصيب الصالح والطالح.
ولكن الصالح -بفضل الله- عنده من غنى القلب بالله -عز وجل- ما يهوِّن عليه هذه المصائب؛ فقلبه مفرغ لحب الله وحده، والرغبة فيما عنده وحده، ورجاء فضله وحده فيعيش أحسن حياة، ولا يجد في الترف سعادة ولا لذة، ولا في الفواحش والمنكرات نعيماً ولا متعة، إنما نعيمه في ركعتين يركعهما يقترب فيهما من ربه وإن تناول القليل من الطعام ولبس البسيط من الثياب.
فحياتنا تحتاج لتغيير كلي؛ كبيرنا وصغيرنا، غنينا وفقيرنا، داعينا ومدعونا، فلن تزيدنا تلك الأنماط الحياتية المستوردة من الغرب والشرق والتي تدفعنا دفعاً لمزيد من الترف الدنيوي وأن يكون هم حياتنا وهدف سعينا هو تكثير أموالنا وتكديس الأصفار أمام أعيننا لا نعبأ أمن حرامٍ أم من حلالٍ، والمهم نيل الشهوات واللذات سواء من فاحشة أو من حلال، وكلما تألمت القلوب فعليها بالهرب للخمر والمخدرات، أو المزيد من الغرق في الشهوات، لن يزيدنا هذا إلا تعاسةً وبؤساً وضيقاً وضنكاً.
فإن قضية الرزق والكسب والفقر والغنى مرتبطة بسلوك المسلم وعقيدته فإن عاش للعبودية جعل الله بين يديه سعة الرزق وكفاية الأحوال بعد حصول الغنى والأمن في القلب (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)(الأنعام:82).
فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لنا وللمسلمين. اللهم آمين.






 , عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة منتَدَاكمً مُنتَدَى الملوك يُرَحبُ بكـُمً ..
, عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة منتَدَاكمً مُنتَدَى الملوك يُرَحبُ بكـُمً ..  إنً كنتَ تَرغَب في الإنضمَامً إلى أسًرَة المنتَدَى سَنتَشَرَفُ بتَسًجيلَكَ .. فَمرُحَبا بالزَائرينَ , وَ العَابرينَ , وَ الأصدقَاء , واَ لأعضَاءَ , بالطَيبينَ وَ الطَيبَات
إنً كنتَ تَرغَب في الإنضمَامً إلى أسًرَة المنتَدَى سَنتَشَرَفُ بتَسًجيلَكَ .. فَمرُحَبا بالزَائرينَ , وَ العَابرينَ , وَ الأصدقَاء , واَ لأعضَاءَ , بالطَيبينَ وَ الطَيبَات  .. وَ بكًل مَن يَثًرَى , أوً تَثُرَى المًنتَدَى بالحِوَارً , وَ المُنَاقَشةَ , وَ المسَاهَمَاتً المُفيدَةَ .. فَلَيًسَ للبُخَلاَء بالمَعرفَة مَكَانُُ هُنَا
.. وَ بكًل مَن يَثًرَى , أوً تَثُرَى المًنتَدَى بالحِوَارً , وَ المُنَاقَشةَ , وَ المسَاهَمَاتً المُفيدَةَ .. فَلَيًسَ للبُخَلاَء بالمَعرفَة مَكَانُُ هُنَا  ..سَاهمَ / سَاهٍمي بكَلمَة طَيبَة , أوً مَقَالً , أوً لَوًحَة , أوً قَصيدَة , أوً فِكرَة , أوً رَأي , أوً خْبرَة تَدفَعً حَيَاتُنَا للأمَامً ... تحيَآت إدَارَة منتَدَى الملوك
..سَاهمَ / سَاهٍمي بكَلمَة طَيبَة , أوً مَقَالً , أوً لَوًحَة , أوً قَصيدَة , أوً فِكرَة , أوً رَأي , أوً خْبرَة تَدفَعً حَيَاتُنَا للأمَامً ... تحيَآت إدَارَة منتَدَى الملوك  ")
")